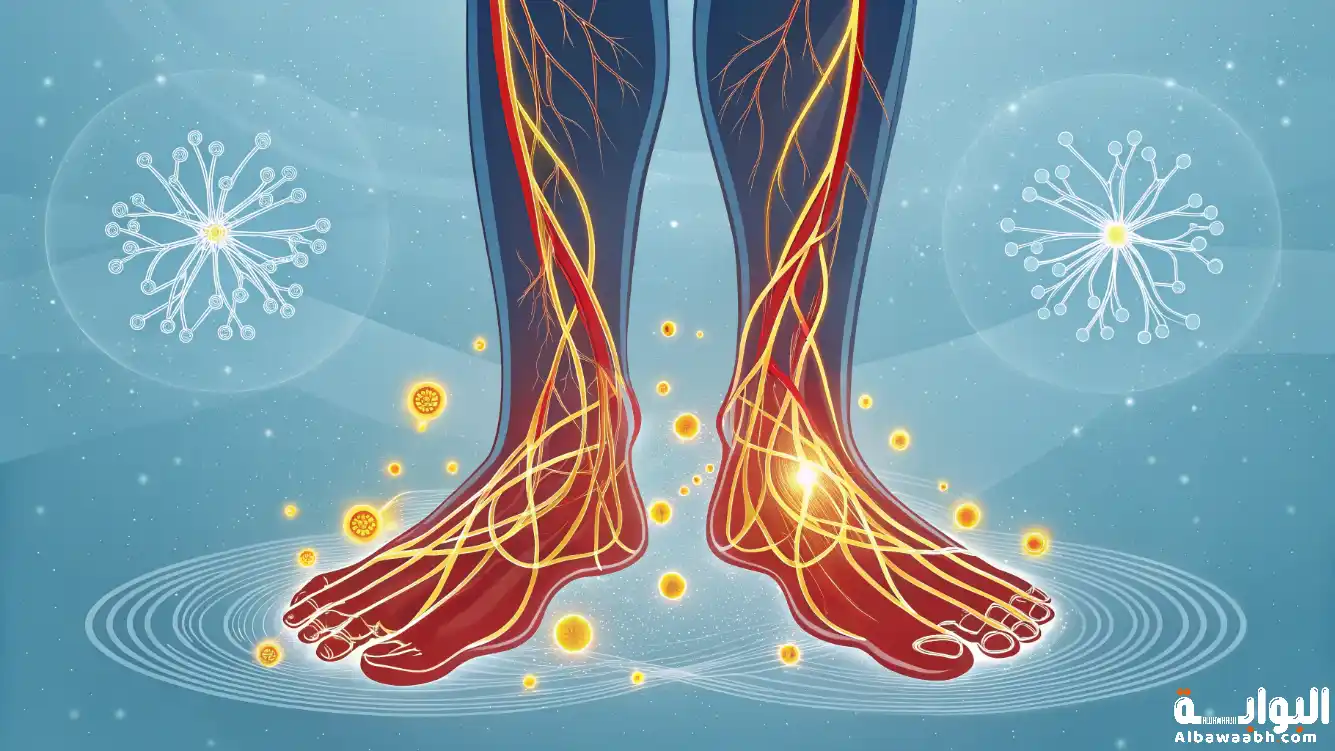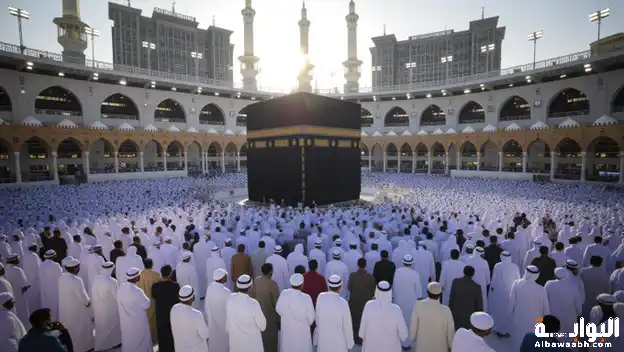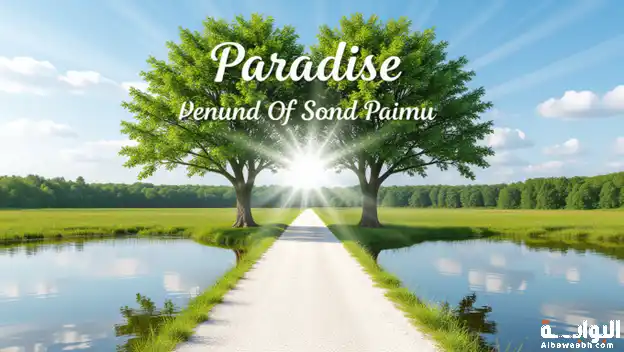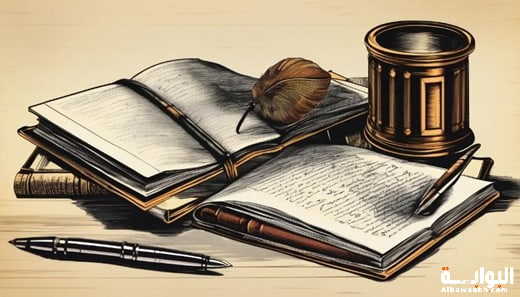المنصور قلاوون سلطان مملوكي

كان المنصور قلاوون. الصالحي يلقب بقلاوون المنتصر، وهو سابع سلاطين المماليك البحرية، حكم من عام 1279 إلى عام 1290 ميلاديًا، تولى السلطة بعد السلطان بركة. الذي يعتقد أن له يدًا في نفيه وحتى وفاته. خلال حياته، تزوج كثير الزوجات والأبناء، أبناء وبنات عززوا علاقاته السياسية. كانت زوجته الأولى فاطمة خاتون، التي أنجبت له ابنه الأكبر صالح علي، اشتهر قلاوون بقيادته عددًا من الحملات الناجحة ضد الصليبيين. حيث سيطر على أراضي من مقاطعة طرابلس ومعقل صليبي ضخم يعرف باسم الحصار، ينحدر قلاوون من سلالة الأتراك القدماء. الذين جندوا لاحقًا كمحاربين مماليك في أربعينيات القرن الثالث عشر.
أصل السلطان قلاوون
المنصور قلاوون: الصعود من المملوك الألفي إلى السلطنة

المنشأ ومكانة “الألفي“
- كان المنصور قلاوون تركيًا قبجاقيًا، وأصبح مملوكيًا في أربعينيات القرن الثالث عشر بعد بيعه.
- عرف بلقب “الألفي“ لأنه اشتراه الملك الصالح مقابل ألف دينار من الذهب. وكان بصعوبة يتحدث اللغة العربية.
الصعود في السلطة ودور صلة القرابة
- ارتقى في الرتب حتى أصبح أميرًا في عهد السلطان بيبرس.
- تعزز نفوذه بزواج ابنه بركة خان. من ابنة قلاوون.
الانقلاب على السلطة والاستيلاء على العرش
- بعد وفاة بيبرس، خلفه ابنه بركة، ولكن اندلعت ثورة أجبرت بركة على التنازل عند عودته من حملة على مملكة كيليكيا الأرمنية.
- تولى قلاوون السلطة الفعلية بصفته أتابكًا. للسلطان الصغير سولاميش (ذو السبع سنوات). ثم أعلن نفسه سلطانًا واتخذ لقب “الملك المنصور“ في أواخر عام 1279.
تحديات داخلية وانتصارات عسكرية
- رفض حاكم دمشق سنغور صعود قلاوون وأعلن نفسه سلطانًا. لكن قلاوون هزمه في معركة عام 1280.
- تصالح قلاوون وسنغور لضرورة العمل المشترك ضد غزو إمبراطور المغول الإلخاني أباقا، ونجحا في صده في معركة حمص الثانية عام 1281.
تصفية الخصوم والسيطرة على الكرك
- نفي كل من بركة وسولاميش وشقيقهما خضر إلى قلعة الكرك الصليبية السابقة.
- توفي بركة هناك عام 1280 (وشاع أن قلاوون سممه)، وسيطر قلاوون على القلعة بالكامل في عام 1286. بعد فترة من سيطرة خضر عليها. [1]
معنى اسم قلاوون
جاء المنصور قلاوون. بلقب آقون من موطنه الأصلى فى آسيا، وانقلب على لسان العامة فى مصر إلى قلاوون ومعنى لقبه آقون هو البطة فى اللغة التركية. لأن كان مقوس الساقين يمشى كالبطة، اسم قلاوون اسم يطلق على السلطان المملوكي المنصور سيف الدين قلاوون، الذي حكم مصر في القرن الثالث عشر الميلادي.
قلاوون وابن تيمية. كان السلطان الناصر محمد بن قلاوون معاصرًا للشيخ ابن تيمية، وكان هناك علاقة بينهما تشكلت في استشارة السلطان لابن تيمية في أمور قانونية وفقهية، وشارك ابن تيمية في حملات عسكرية، كما حدث أن استفتى السلطان ابن تيمية في مسألة ترتبط بقتل عدة من القضاة الذين كانوا سببًا في معارضة السلطان.
تعرف أيضًا على: ماو تسي: تونغ الزعيم الصيني مؤسس جمهورية الصين الشعبية وقائد الثورة الشيوعية

مسجد السلطان قلاوون
بني المسجد على يد الناصر محمد عام ١٣١٨ خلال فترة حكمه الثالثة والأطول (١٣٠٩-١٣٤٠) كمسجد ملكي للقلعة. وربما كان في موقع المسجد الأيوبي الجامع الذي أمر الناصر محمد بهدمه وإعادة بنائه. ويرجّح أن صلاح الدين الأيوبي هو من أسس المسجد الأيوبي كجزء من أعماله في القلعة.
تعرف أيضًا على: بليز باسكال: الفيلسوف والعالم الذي جمع بين الرياضيات والإيمان
يشكل المسجد كتلة مستطيلة قائمة بذاتها، بينما يمكن تفسير مظهره الخارجي البسيط بالطابع العسكري لموقعه. يتبع المسجد مخطط الأعمدة مع النمط القياسي للفناء المستطيل، مع محراب في جهة القبلة وأروقة تحيط بجوانبه الثلاثة الأخرى. تتكون أروقة المحراب والفناء من أعمدة رخامية ذات تيجان من عصر ما قبل الإسلام تحمل أقواسًا مدببة ذات صلب من الأبلق، يعلو كل قوس زوج من النوافذ ذات الأقواس المدببة. علاوة على ذلك، تشكل هذه النوافذ الجزء السفلي من الجدار المسنّن الذي يرجّح أنه أضيف فوق الأروقة عام 1335. بالتالي، يجمع تصميم المسجد بين التراث المعماري القديم والتعديلات اللاحقة.
يمثل معرض المئذنتين حدثًا فريدًا بين مآذن مصر الباقية، يعتقد أن أن أعمدة المئذنتين وقمتيهما بنيتا عام ١٣٣٥. وهما المئذنتان الوحيدتان في مصر اللتان تقع قواعدهما أسفل مستوى سطح المسجد. ويحتمل أن يكون سبب ذلك هو أن هذه القواعد تسبق رفع السقف عام ١٣٣٥.
الابتكارات المعمارية في المسجد: من الفسيفساء الإيلخانية إلى المآذن المتعرجة
ووفقًا للمقريزي، استعان أمير قوصون بمهندس معماري تبريزي لبناء مسجده ١٣٢٩-١٣٣٠، الذي كان يضم مئذنتين على غرار مآذن مسجد الوزير علي شاه الغيلاني في تبريز لا يوجد أي منهما اليوم، وكان من المألوف أيضًا في بلاد فارس الإيلخانية استخدام الفسيفساء الخزفية، التي يتم تنفيذها على هذا الجزء العلوي المنتفخ باللون الأخضر والأبيض والأزرق، مثل تلك الموجودة على السبيل الذي ألحقه الناصر محمد بمدرسة والده المنصور قلاوون. السبيل 1326، الفسيفساء ربما بعد 1348، مع شريط من الفسيفساء الخزفية البيضاء حول عنق المصباح، تشكل الشرفات حول قاعدة القمة المنتفخة للمئذنة الشرقية أقدم تجربة معروفة لهذه التقنية في قاعدة قبة القاهرة.
نحت عمود الطابق الأول من المئذنة الغربية الدائري بنمط متعرج أو متعرج عمودي؛ أما الطابق الثاني، وهو دائري أيضًا. فقد نحت بنمط متعرج أفقي أو متعرج، تظهر هذه الزخارف المتعرجة لأول مرة حول أعمدة المآذن المصرية في هذا المسجد. تواصل المئذنة الغربية التقليد القاهري بوضع المآذن عند بوابات الأساسات، ويفسر موقعها عند البوابة الغربية. التي كانت المدخل الاحتفالي المواجه لشقق السلطان. تميز أعمدة المئذنة عن أعمدة المئذنة الشرقية بنقوش حجرية فخمة.
رفع ارتفاع المسجد، وأعيد بناء سقفه، وأضيفت قبة خشبية مبلطة بالقرميد الأخضر فوق المقصورة عام ١٣٣٥، كان المسجد آنذاك المسجد الملكي لسلاطين المماليك حيث كانت تُقام صلاة الجمعة. وظل من أروع مساجد المدينة حتى انهارت القبة الخشبية الأصلية المبلطة فوق المقصورة ذات الأروقة التسعة أمام المحراب في القرن السادس عشر، ونقل السلطان سليم الدادوه الرخامي إلى إسطنبول. [2]
تعرف أيضًا على: الرازي طبيب وكيميائي مسلم
حكم أسرة قلاوون
لم يكن المماليك يؤمنون بمبدأ وراثة الحكم، وإنما كانت الحكم دائمًا للأمير الأقوى، الذي يتمكن أن يحسم الصراع على السلطة لصالحه، ويقابل لأي محاولة للخروج عليه، ولكن أسرة المنصور قلاوون. تمكنت أن تكسر هذه القاعدة، وتخرج عن ذلك المحتوي؛ فقد ظل المنصور قلاوون. وأولاده وأحفاده يحكمون دولة المماليك لأكثر من قرن من الزمان. مع كل ما واجهوه من مؤامرات وانقلابات. يتبعها اغتصاب للسلطة، بيد أن هؤلاء المغتصبين لم يستقروا في الحكم طويلاً؛ إذ سرعان ما كان يتم عزلهم لتعود السلطة مرة أخرى إلى أسرة قلاوون، ولعل هذا ما كان يتم دائمًا عقب وفاة كل سلطان.
تعرف أيضًا على: الملكة نازلي: والدة الملك فاروق
فبعد وفاة السلطان قلاوون تولى ابنه الأكبر خليل قلاوون أمور السلطة، ولكنه كان خلاف أبيه. فقد اتسم بالغلظة والحدة، وكان متعجرفًا قاسيًا في معاملة مماليكه؛ مما أثار عليه النفوس، وأوغر ضده الصدور. غير أنه تمكن بشجاعته أن يطرد الصليبيين من عكا، وأن يحقق حلم أبيه بوضع خاتمة للحروب الصليبية التي استمرت قرنين من الزمان.
لكنه لم يتمتع طويلاً بالنصر؛ فما لبث أن تآمر عليه عدة من أمراء المماليك. واستغلوا فرصة خروجه يومًا للصيد، فانقضوا عليه وقتلوه.
صعود لاجين وإصلاحاته وسيناريو العودة الثالثة للناصر محمد
وهكذا صار الناصر محمد بن قلاوون سلطانًا على مصر بعد مقتل أخيه؛ فجلس على العرش، وهو لا يزال في التاسعة من عمره.
واُخْتِير الأمير “كتبغا” نائبًا للسلطنة، فصار هو الحاكم الفعلي للبلاد، بينما لا يحوز السلطان الصغير من السلطة إلا اللقب الذي لم يستمر له أيضًا أكثر من عام؛ فقد تمكن كتبغا أن يقنع الخليفة العباسي بعدم أهلية الناصر للحكم لصغر سنه، وأن البلاد في داع إلى رجل قوي يهابه الجند، وتخشاه الرعية، فأصدر الخليفة مرسومًا بخلع الناصر وتولية كتبغا مكانه.
تعرف أيضًا على: من هو بولس الرسول؟ سيرته ودوره في نشر المسيحية ورسائله الشهيرة
اقترنت مدة سلطنة كتبغا بأحداث كثيرة أثارت ضده الشعب، وجعلته يكرهه؛ وقد أغرى ذلك الأمير لاجين بانتزاع السلطة والاستيلاء على العرش، وبعدها استدعى الناصر محمد وطلب منه السفر إلى الكرك.
جهود السلطان لاجين في كسب الرعية ونهاية حكمه وعودة الناصر محمد
وسعى السلطان لاجين إلى التقرب من الناس بوساطة تخفيف الضرائب، كما حرص على تحسين صورته بين الرعية بوساطة أعمال البر والإحسان التي قام بها، فنال بتأييد الشعب له، لا سيما بعد أن انخفضت الأسعار، وعمّ الرخاء، وعمد لاجين إلى إظهار تقديره للعلماء. وبعده عن اللهو، وأحسن السيرة في الرعية، ولكن عددًا من الأمراء تآمروا عليه، فقتلوه وهو يصلي العشاء.
صار الطريق خاليًا أمام السلطان الناصر محمد، للرجوع إلى عرشه من جديد، واستقر الرأي على استدعاء الناصر فذهبت وفود من الأمراء إليه. وعاد “الناصر” إلى مصر، في موكب حافل، فلما دخل القلعة. وجلس على العرش، جدد الأمراء والأعيان البيعة له. ولم يكن عمره يتجاوز الرابعة عشرة آنذاك.

تعرف أيضًا على: الأم تريزا: قديسة الفقراء
ختاما، المنصور قلاوون. ترك بصمةً لا تمحى في التاريخ، لا تزال تثير الإعجاب والهيبة، براعته الاستراتيجية وإنجازاته العسكرية مهدت الطريق لعصر ذهبي في تاريخ مصر. مهد الطريق لحكام المستقبل للنجاح والازدهار. وكانت قيادته القوية مثالاً يحتذى به. يتجاوز إرث المنصور قلاوون. فتوحاته العسكرية بكثير. فقد كان أيضًا راعيًا عظيمًا للفنون والعلوم، مهيئًا بيئةً للإبداع والنمو الفكري، توافد العلماء والشعراء والفنانون إلى بلاطه، مدركين أنهم سيحظون بالدعم والاحتفاء. أدرك قلاوون أهمية الثقافة والمعرفة، فلم يدخر جهدًا في رعايتها.
المراجع
- military-history.fandomAl Mansur Qalawun _بتصرف
- archnetMasjid al-Sultan al-Nasir Muhammad ibn Qalawun _بتصرف
مشاركة المقال
هل كان المقال مفيداً
الأكثر مشاهدة
ذات صلة

طرزان: الرجل الذي عاش في الغابة

من هو سيرجيو ماتاريلا رئيس إيطاليا؟

جواهر لال نهروا: قائد استقلال الهند

هنري الخامس: القائد العسكري الذي سطّر أمجاده في...

من هن فتيات القوة؟ شخصيات لا تُنسى
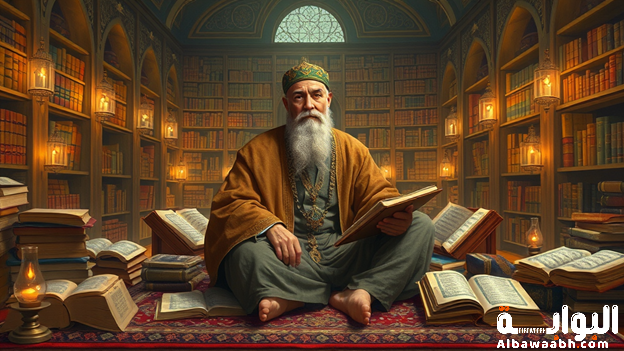
فخر الدين الرازي: مفسر القرآن

سيرة هند القحطاني حضور دائم بين التأثير والانتقاد

فاسكو دا جاما المستكشف البرتغالي الذي وجد طريقًا...

فاجيرالونغكورن ملك تايلاند: السيرة الذاتية والإنجازات

دينيس ريتشي: مبتكر لغة C ومؤسس نظام Unix...

عباس محمود العقاد: أدباء العرب

رجب طيب أردوغان زعيم تركيا

أنطوان لافوازييه: أبو الكيمياء الحديثة

جهانكير: إمبراطور المغول في الهند وأبرز حكامه في...