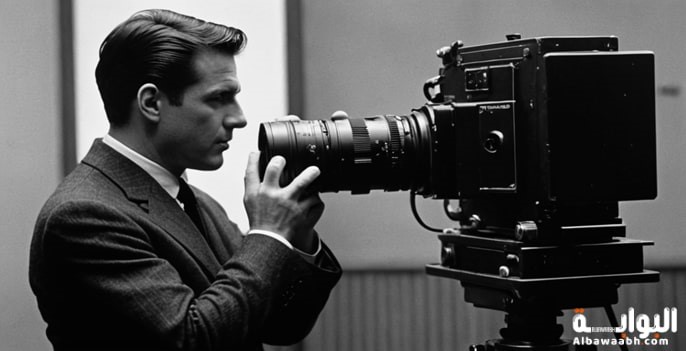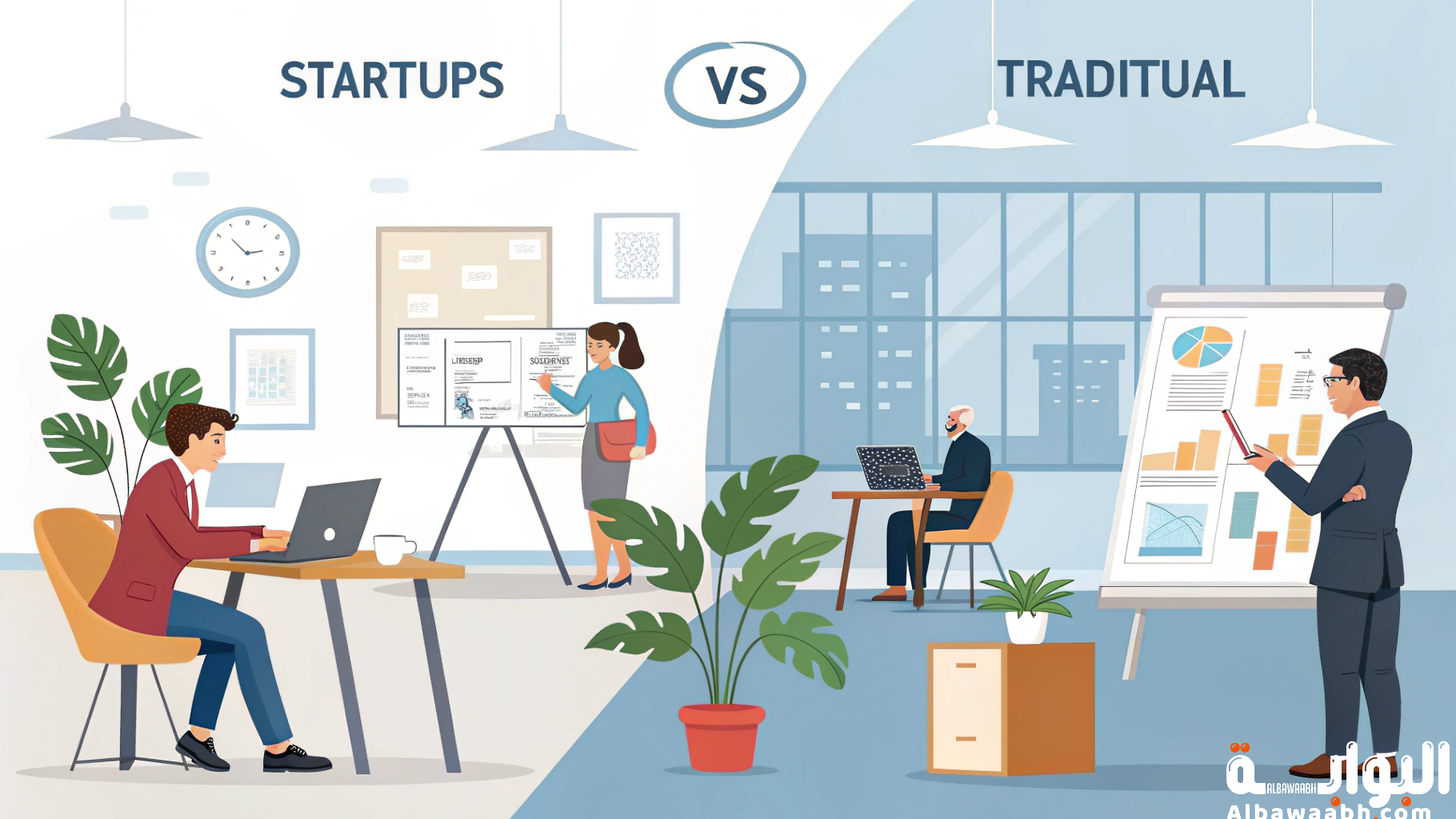دعوة الأنبياء للتوحيد: رسالة السماء الواحدة

عناصر الموضوع
1- وحدة الدعوة بين الأنبياء
2- مواجهة الشرك والأوثان
3- منهج الإقناع بالحجة
4- تحمّل الأذى في سبيل الله
5- نماذج من دعواتهم
6- ديمومة التوحيد في كل عصر
يجب الإقرار والتصديق القاطع بأن الله أرسل جميع الرسل بعقيدة واحدة، وهي التوحيد. أما الشرائع، فهي تختلف في الأوامر والنواهي؛ فقد يكون الشيء محرمًا في شريعة معينة ثم يصبح مباحًا في شريعة أخرى، والعكس صحيح. كما قد يكون الأمر خفيفًا في شريعة معينة ثم يُشدد في أخرى.
وذلك يعود إلى الحكمة البالغة والحجة القاطعة التي يتمتع بها الله تعالى.
1- وحدة الدعوة بين الأنبياء
في هذا السياق، يقول الله تعالى: “وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون” [الأنبياء: 25]. هذه الآية تشبه الآية السابقة، حيث يوضح سبحانه أن دعوة جميع الرسل هي دعوة للتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، دون سواه، حتى وإن كان قوله “لا إله”.
أولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
إن دعوة الأنبياء واحدة، منذ آدم عليه السلام وحتى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: “والأنبياء إخوة لعلاَّت أمهاتهم شتى ودينهم واحد”.
هذه الوحدة بين الأنبياء عليهم السلام ليست عبثاً، بل هي دعوة للتقيد والاقتداء بها من قبل الدعاة، لتجنب الفرقة والخلاف، كما قال تعالى: “إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون”.
إن الخلط بين ما يجوز فيه الاجتهاد وما لا يجوز في أولويات الدعوة قد أدى إلى حدوث خلافات وشقاقات بين الدعاة، وهو ما يظهر جليًا في تفرق الأمة إلى أحزاب وفرق وانتماءات، وغالبًا ما يكون سبب ذلك هو الاختلاف حول أولويات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
إن المنهج الذي يجب أن تتوحد عليه الأمة لتصبح حقًا “أمة واحدة” هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين تلقوا هذا المنهج بوحي من الله تعالى وليس من خلال اجتهادات بشرية. ولذلك، أُمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، كما جاء في قوله: ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقتَدِه ﴾، وأيضًا في قوله: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾.
ولكي نصل إلى نتيجة دعوية مقبولة من الجميع في هذا المبحث، فإننا سنستند إلى نصوص القرآن الكريم التي تناولت دعوة الأنبياء عليهم السلام. بالإضافة إلى بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خاصة وأن هذه القضية تمثل أساسًا راسخًا في الدعوة. تمس أولوياتها وتعود إلى الأنبياء عليهم السلام، لذا ندعو الإخوة الدعاة في كل مكان إلى الالتزام بهذه الأولويات لتكون جزءًا أساسيًا في عملهم. [1]
2- مواجهة الشرك والأوثان
من بين الأمور المهمة أيضًا محاربة الشرك بأنواعه، حيث يعتبر الشرك الأكبر، مثل دعوة الأموات والاستغاثة بهم أو بالأصنام والأشجار والأحجار، كفرًا أكبر. كما أن إنكار الشيوعية لوجود الله، وللشرائع، وللجنة والنار والآخرة يعد ردة كبرى، وهي أعظم من كفر اليهود والنصارى، نعوذ بالله. فالشيوعية، التي تمثل إلحادًا وإنكارًا لوجود الله وما جاءت به الرسل، وتكذيبًا بالآخرة، تعتبر من أخطر أنواع الكفر بالله، وصاحبها أكفر من اليهود والنصارى، نعوذ بالله.
أيضًا، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بهم، والنذر لأصحاب القبور. والتعلق بالأموات لطلب الشفاء والنصر على الأعداء، وطلب المدد والغوث منهم، يعد شركًا بالله تعالى. حتى لو قال الشخص إنهم لا ينفعون ولا يضرون، فإن الاعتقاد بأن الميت أو غيره يمكن أن ينفع أو يضر دون الله يعتبر شركًا في الربوبية. فإذا قال شخص ما إن السيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعون أو يضرون سواء أحياءً أو أمواتًا، فإن هذا يُعد ردة عند جميع أهل العلم وكفرًا أكبر. كما أن الاعتقاد بأن أي مخلوق، سواء كان من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو الأموات، يمكن أن يجلب النفع للناس يعتبر أيضًا كفرًا.
يتعين على علماء المسلمين في كل مكان أن ينبهوا الناس إلى هذا الخطر. وأن يوضحوا للجمهور حقيقة الدين والتوحيد ومعنى “لا إله إلا الله”. فمعنى هذه العبارة هو أنه لا معبود بحق إلا الله، وهو سبحانه وتعالى الذي يجب أن يُدعى ويُستغاث به، وهو المعبود الحق، بينما ما سواه يعتبر معبودًا بالباطل.
كما قال الله تعالى:
“ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ” [الحج:62]. لذا، فإن هذه الأمور العظيمة يجب على الدعاة والعلماء توضيحها للناس، ويجب أن تكون من أولوياتهم، أهم من بعض أحكام الصلاة والزكاة وغيرها، لأن الأساس هو توحيد الله والإخلاص له. فلا زكاة ولا صوم ولا حج إلا بعد التأكد من صحة هذا الأصل، وهو توحيد الله والإخلاص له ودخول العبد في الإسلام. [2]
3- منهج الإقناع بالحجة
مجموعة من الافتراضات أو المقدمات تشكل أساس الاستدلال أو الاستنتاج. مما يؤدي إلى استنتاج أو نتيجة معينة. تتكون الحجة من مقدمة واحدة أو أكثر ونتيجة واحدة. يستخدم المنطق الكلاسيكي غالبًا كوسيلة للتفكير، حيث يتبع الاستنتاج بشكل منطقي الافتراضات أو الأدلة المقدمة. ومن التحديات المرتبطة بذلك أنه إذا كانت مجموعة الافتراضات غير متسقة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنتاجات متناقضة. لذا، من الشائع التأكيد على ضرورة أن تكون مجموعة الافتراضات متسقة. كما يعتبر من الممارسات الجيدة أن تكون هذه المجموعة هي الحد الأدنى من الافتراضات اللازمة لاستنتاج النتيجة. تعرف مثل هذه الحجج باسم حجج MINCON، وهو اختصار لـ “minimal fixed”، وقد تم تطبيقها في مجالات مثل القانون والطب. من ناحية أخرى. يستكشف النهج غير الكلاسيكي في الحجج الحجج المجردة، حيث يعتبر “الحجة” مصطلحًا أساسيًا. بالتالي لا تؤخذ أي بنية داخلية للحجج بعين الاعتبار.
نشأت نظرية الحجاج في إطار التأسيسية. وهي نظرية معرفية ضمن الفلسفة. تهدف هذه النظرية إلى وضع أسس للمطالبات من خلال أشكال المنطق والمواد المتعلقة بالقوانين الواقعية. وذلك لبناء نظام عالمي للمعرفة. وقد اشتهرت الطريقة الديالكتيكية بفضل أفلاطون واستخدامه لسقراط في ممارسة التشكيك النقدي تجاه شخصيات تاريخية متنوعة. ومع مرور الوقت. بدأ علماء الحجاج في الابتعاد عن فلسفة أرسطو المنهجية والمثالية التي قدمها أفلاطون وكانط، حيث بدأوا في التشكيك في فكرة أن صحة مقدمات الحجة تعتمد على الأنظمة الفلسفية الرسمية. ونتيجة لذلك، توسع نطاق هذا المجال.
كان الفيلسوف شايم بيرلمان من أبرز المساهمين في هذا الاتجاه، حيث قدم مع لوسي أولبريشتس-تيتيكا المصطلح الفرنسي “la nouvelle rhetorique” في عام 1958، لوصف نهج في الحجة يتجاوز مجرد تطبيق القواعد الرسمية للاستدلال. وتعتبر وجهة نظر بيرلمان في الحجة أقرب إلى المنظور القانوني، حيث تلعب قواعد تقديم الأدلة والردود دورًا محوريًا. [3]
4- تحمّل الأذى في سبيل الله
من المعروف أن تقديم النصيحة والصبر على الأذى الناتج عنها يعد من أعظم الوسائل، بعد الله تعالى، في نشر دينه وتعزيز كلمته. ولا يمكن أن يكون هناك نصيحة لمن لا يتحمل الأذى الذي قد ينجم عن أدائها. يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ).
يمكن للإنسان أن يكون رحيمًا ويتبادل الرحمة، لكن هل يكفي أن يكون الشخص رحيمًا فقط؟ ماذا يحدث له إذا تعرض للأذى أو لتجاوزات الآخرين؟ وماذا لو كان مظلومًا؟
يذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه “كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي وجذبه بشدة حتى رأيت أثر حاشية البرد على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضحك، ثم أمر له بعطاء”.
لقد عفا الرسول الأعظم عن هذا الأعرابي الذي تصرف بهذه الطريقة الفظة مع قائد وزعيم المسلمين. ولو أراد النبي محاسبته على هذا التصرف، لكان بإمكانه ذلك، لكنه اختار العفو. فالأعراب غالبًا ما يتسمون بالغلظة، وهي نتيجة طبيعية لبيئتهم الصحراوية. [4]
5- نماذج من دعواتهم
آدم علية السلام
“رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا”.
” رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ
نوح علية السلام
“رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128)”. [البقرة – 127-128].
“رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
إبراهيم علية السلام
“إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ”.
أيوب علية السلام
“رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. [5]
6- ديمومة التوحيد في كل عصر

الأنسنة:
بما أن الله هو الوحيد الذي يمتلك العلم والقدرة بشكل مطلق ودائم، فإن كل ما يكتسبه الإنسان من معارف وما ينتجه من علوم ومذاهب وتوجهات وتشريعات، يظل نسبيًا وقاصرًا. حتى لو كان ناتجًا عن أعلى درجات العلم والفهم والتقوى. هذه المعارف قابلة للتصحيح والتطوير، وتتطلب التغيير المستمر. أي تردد في ذلك، عند وجود الدوافع الاجتماعية والعلمية، يتعارض تمامًا مع عقيدة التوحيد.
المساواة:
أحد الأبعاد الأساسية للتوحيد هو البعد الحقوقي، حيث يمثل التوحيد مبدأً يمنع جميع أشكال الاستعلاء والاستكبار والتجبر، سواء في مجالات السياسة أو الاجتماع أو الاقتصاد أو المعرفة، وحتى في الفكر الديني.
الاتحاد:
يمثل التوحيد تضامنًا إنسانيًا من أجل القيم المطلقة. وخاصة الحق والعدل والسلام. وهذا ما يحقق فعليًا توحيد الأسماء والصفات، ويضمن الحفاظ على أبعادها العملية التي تؤثر إيجابيًا في حياة الناس.
القد الذاتي:
يعتبر المرحلة الأولى في عملية التصحيح والتطوير، حيث لا يمكن تجاوز القصور أو تحقيق التقدم بدونه. يتطلب ذلك وعي الإنسان بذاته وإمكاناته. إذ أن توجهه نحو الله الواحد يستلزم الاعتراف بأن الحقيقة المطلقة هي بيد هذا الواحد.
وفى نهاية هذا المقال أرجو أن أكون ساهمت في إيضاح تلك العناصر بشكل مبسط سهل وشرحها بالشكل الصحيح المناسب.
المراجع
- شبكة الالوكةأولويات الدعوة في منهج الأنبياء عليهم السلام-بتصرف
- موقع الشيخ بن باز ضرورة محاربة الشرك بأنواعه-بتصرف
- ويكبيديانظرية الحجة-بتصرف
- شبكة الالوكةتحمُّل الأذى في سبيل الله-بتصرف
- Casino.orgدعية الأنبياء من القرآن الكريم-بتصرف
مشاركة المقال
وسوم
هل كان المقال مفيداً
الأكثر مشاهدة
ذات صلة

ما هو حكم صيام رمضان لمريض السكر؟

النوافل ومواضع أدائها طوال اليوم

ما علاقة العبادة بالإيمان

هل خروج الدم من الأنف يفسد الصيام؟

ماهى فوائد ماء زمزم

ألم الرجل عند قراءة سورة البقرة

قصة آدم عليه السلام: بداية الخلق والعبرة

استخراج أحكام التجويد في سورة الملك
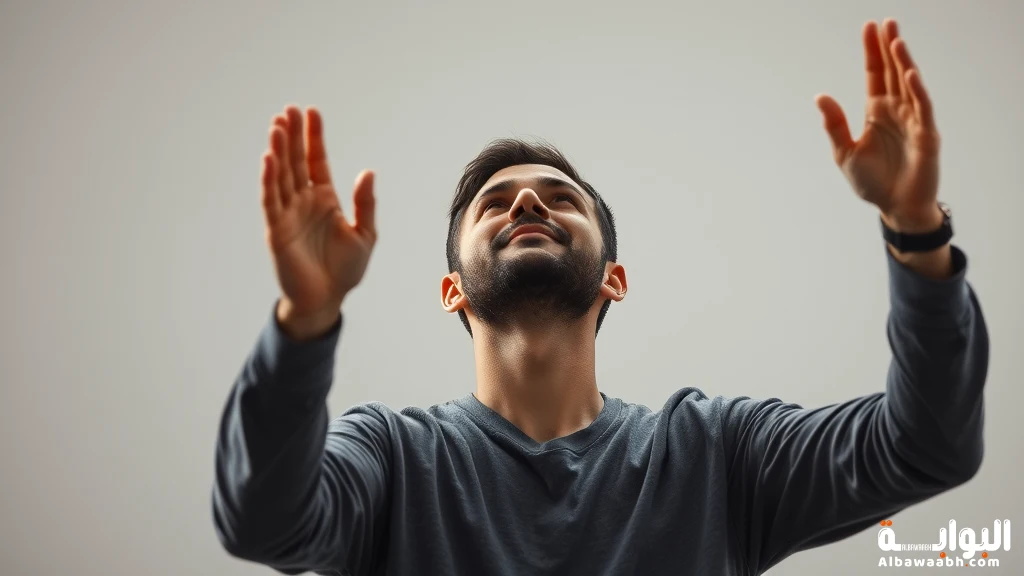
صيام اثنين وخميس في شعبان: الحكم والفضل

أفضل دعاء الاب المتوفي

أسباب الانحراف عن العقيدة عوامل الضعف وسبل العلاج

ترتيب الولاية بعد وفاة الأب
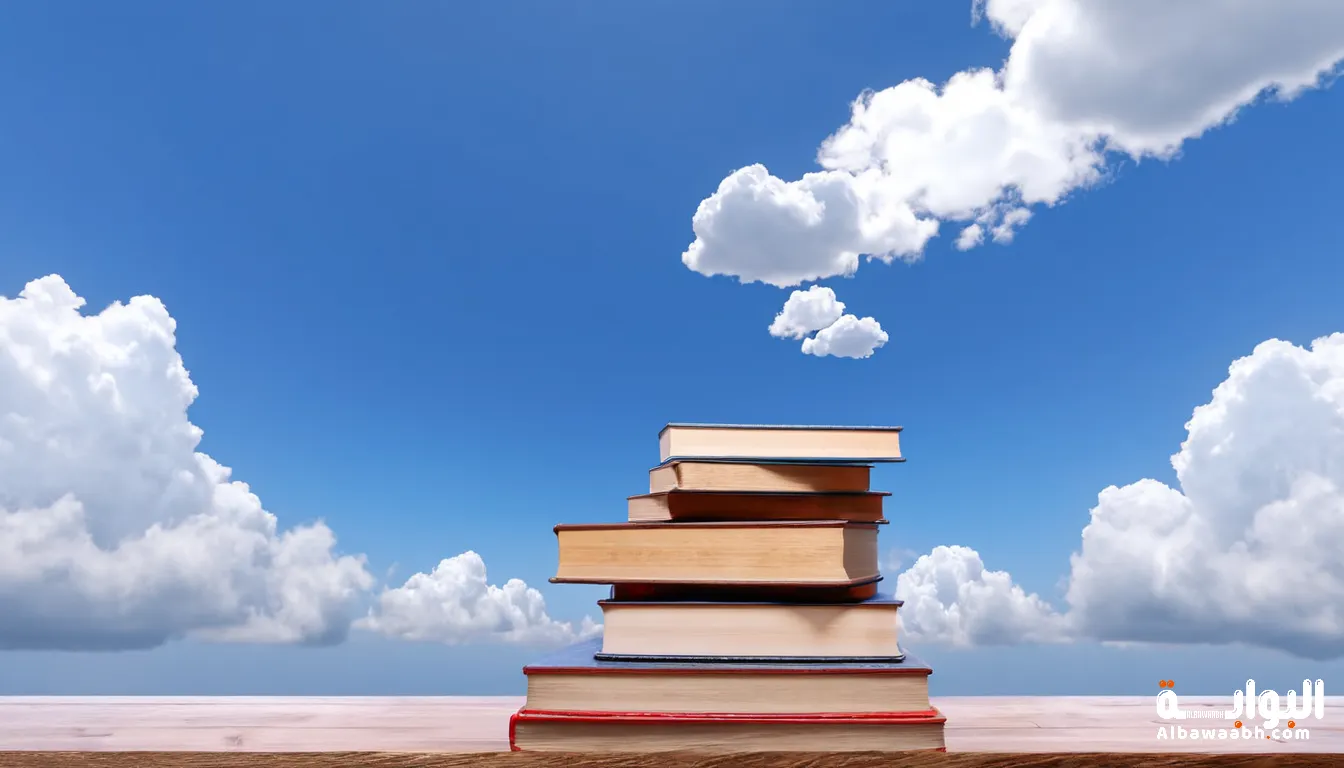
ترتيب الكتب السماوية: مسيرة التشريع الإلهي عبر العصور

أنساب الصحابة خارطة واسعة لبيوت العرب والإسلام